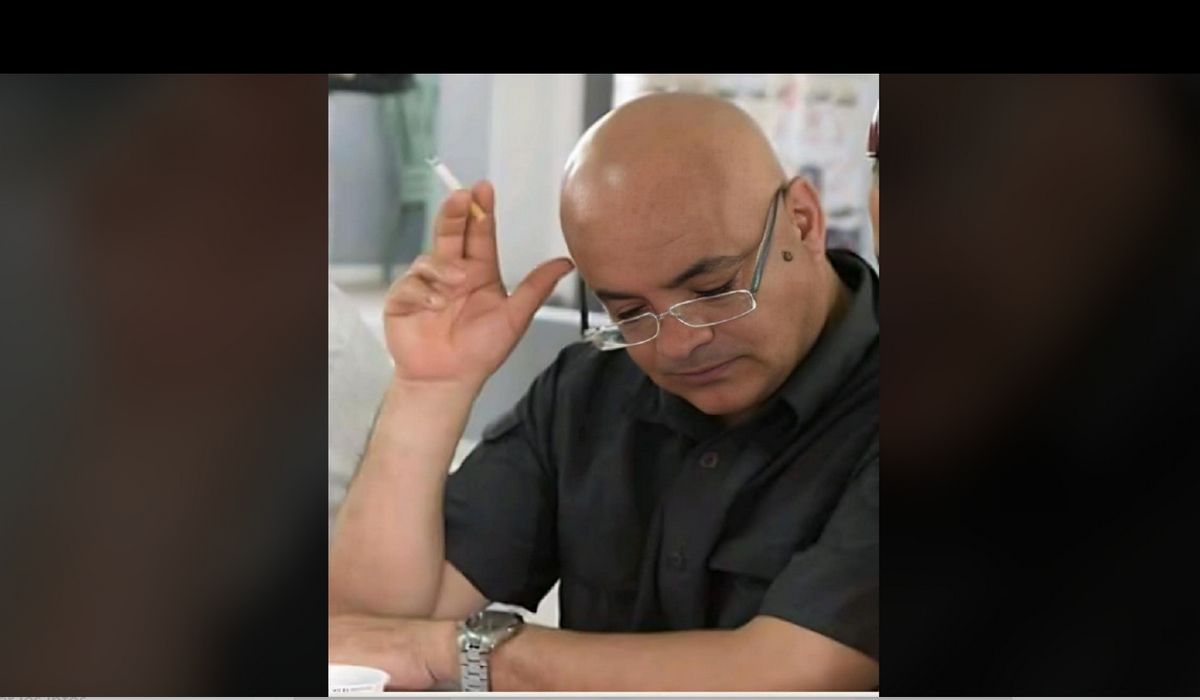
المنظومة الحقوقية بين العجز الأخلاقي وانكشاف الأجندات الخفية…مُحمد خلف الله
لم يكن العالم بحاجة إلى دليل جديد على زيف الخطاب الغربي حول “حقوق الإنسان” حتى جاءت الإبادة في غزة، لتُعرّي المنظومة الحقوقية الدولية من آخر أقنعتها.
ففي الوقت الذي كانت فيه طائرات الاحتلال تمحو أحياءً كاملة وتستهدف المستشفيات والمدارس والمخيمات، صمت الجميع ، أو اكتفوا ببيانات رمادية لا تُدين الجاني ولا تُنصف الضحية.
وانكشف خداع امتد لعقود من الزمن ، ازدواجية المعايير، وانتقائية المواقف، وتوظيف “الإنسانية” لخدمة المصالح السياسية والاقتصادية للغرب وحلفائه.
لقد انهارت الصورة الأسطورية للغرب كحارس للقيم الكونية. تهاوت مصداقية مؤسساتٍ كانت تملأ العالم ضجيجًا عند كل أزمة في دول الجنوب، لتختفي أو تتواطأ حين يكون الجلاد “إسرائيليًا”.
لقد اكتشف الناس أن الحقوق هناك ليست مبدأً أخلاقيًا بل ورقة ضغط تُستخدم متى شاءت القوى الكبرى، وتُسحب متى كانت الضحية عربية أو مسلمة أو مناهضة للهيمنة الغربية.
انعكس هذا الانكشاف العالمي على المنظمات التونسية لحقوق الإنسان، التي وجدت نفسها في قلب أسئلة محرجة تتعلق بالتمويلات الأجنبية، وبالعلاقات المريبة مع دوائر مانحة تتحكم في نغمة المواقف واتجاه البيانات.
و تحولت عناوين النضال الحقوقي، إلى طرفٍ يثير الريبة أكثر مما يثير الثقة، بعد أن غاب صوتها في القضايا المصيرية، وتحوّل خطابها إلى نسخة باهتة من أجندات غربية لا تمتّ إلى السياق التونسي والعربي بصلة.
الناس الذين تابعوا الإبادة في غزة، وشهدوا الصمت الدولي المطبق، باتوا أكثر وعيًا بالجانب المظلم لهذه المنظومات. فهم يرون اليوم أن كثيرًا من المنظمات الحقوقية في بلدانهم ليست سوى أذرع ناعمة لنفوذ خارجي، تعمل تحت عناوين إنسانية بينما تخدم مصالح سياسية وثقافية محددة.
وفي خضم هذا الشك المتزايد، جاءت الفضيحة الأخيرة لتعمّق أزمة المصداقية:
الحقوقي الكبير يكتب منشورًا يمجّد فيه امرأة حصلت على جائزة نوبل للسلام، واصفًا إياها بأنها “مناضلة من أجل الحريات والديمقراطية في فنزويلا”، متغاضيًا تمامًا عن كونها من أبرز المؤيدين للكيان الصهيوني، ومن المبررين لجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
الحديث هنا عن ماريا كورينا ماتشادو، إحدى الوجوه السياسية اليمينية في فنزويلا، التي لم تخفِ في أي مناسبة انحيازها الكامل للاحتلال الإسرائيلي، بل اعتبرت ما يفعله في غزة “حقًّا مشروعًا في الدفاع عن النفس”.
كيف يمكن لمن يقود منظمة تُعنى بحقوق الإنسان أن يحتفي بشخصية كهذه؟
وأي تبرير يمكن أن يقدمه لتغاضيه عن هذا التورط الأخلاقي الصارخ؟
إن هذا الموقف لا يمكن فصله عن منظومة أوسع من التبعية الفكرية والسياسية التي طالت عددًا من المنظمات الحقوقية المحلية.
فباسم التحديث والانفتاح، تمّ تسويق خطابٍ غريبٍ عن السياق الوطني
لقد سقط القناع.
ها هو الوهم الحقوقي المستورد يتهاوى أمام وعي شعوبٍ لم تعد تنطلي عليها لغة المنح المشروطة ولا شعارات “التنوير الانتقائي”
المصممة على مقاس الدوائر المانحة.










