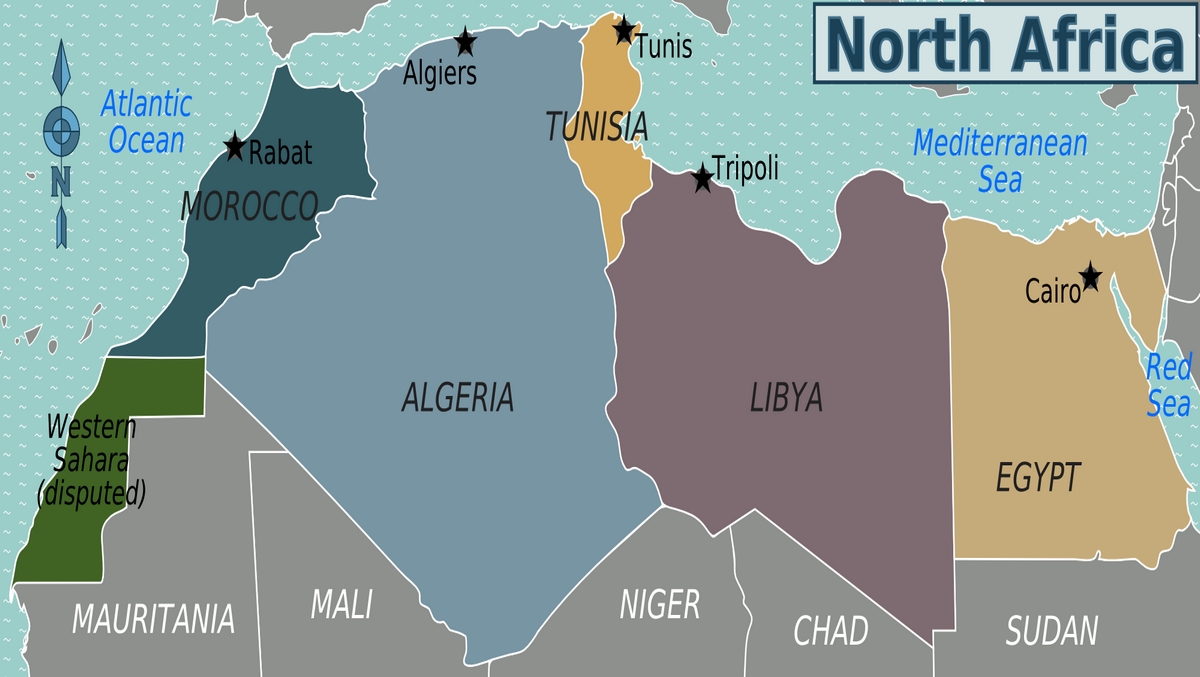صحيفة القدس العربي طرحت السؤال : هل توقع بورقيبة طوفان الأقصى؟
وكيف يحصل ذلك من رجل عرف بأنه كان واحدا من الداعين إلى الإقرار بهزيمة العرب أمام إسرائيل؟ قد يقول البعض، لكن هل يذكر الفلسطينيون اليوم ما قاله لهم رئيس تونس الراحل قبل نحو ستين عاما من الآن، أي شهور قليلة فقط قبل ما عرف بالنكسة؟ من المؤكد أن عدة انطباعات وأفكار تدور حوله، غير أن كثيرين قد يستحضرون مقاطع من خطاب أريحا الذي ألقاه في 1965 أمام سكان المخيمات وقال لهم فيه: «على ضوء ما أتيح لي من تجربة شخصية، وما خضته من كفاح طويل تواصل أربعا وثلاثين سنة، أود أن ألفت انتباهكم إلى أن العاطفة المشبوبة والمشاعر المتقدة، التي ترتسم آثارها على وجوهكم لا تكفي وحدها للانتصار على الاستعمار. ولئن كان هذا الحماس ضرورة من ضرورات الكفاح لدفعه والإبقاء على جذوته، فإن التضحية والاستشهاد هما اللذان يضمنان النتيجة المرجوة والفوز العظيم». قبل أن يحذرهم من مغبة الوقوع في كارثة أخرى بعد كارثة 1945 حين شدد على أنه «ومع روح التضحية والحماس لا بد من قيادة حكيمة تجتمع فيها خصال جمة من فكر ثاقب وتخطيط بعيد المدى وتبصير بالأحداث ودراسة لنفسية العدو، ومراعاة لتفاوت القوى بيننا وبين الخصم، واعتبار لإمكانياتنا الحقيقية، مع ضبطها وتقديرها بأكثر ما يمكن من التحري والموضوعية، حتى لا يؤول بنا الأمر إلى مغامرة ثانية تكون نكبة أخرى تعود بنا أشواطا إلى الوراء».
لكن أكثر ما علق في الأذهان من ذلك الخطاب الشهير، الذي اتهم على أثره بورقيبة بالخيانة والخروج عن الصف والإجماع العربيين، والتنكر للحقوق المشروعة للفلسطينيين، هو دعوته للقبول بقرار التقسيم كحل ظرفي أو تكتيكي يسمح لهم لاحقا، ومن خلال اتباع سياسة المراحل بالوصول إلى غايتهم. لقد عرض عليهم تجربته الشخصية وقال لهم: «إن كفاحنا في تونس لم ينجح في بضع سنين إلا لأننا أعرضنا عن سياسة المطالبة بالكل أو لا شيء» واعتبرنا كل خطوة نخوضها أداة تقربنا من هدفنا، الذي بقينا متمسكين به وهو الاستقلال.. إننا لو رفضنا الحلول المنقوصة، مثلما رفض العرب الكتاب الأبيض والتقسيم، لظلت تونس إلى هذا اليوم منكوبة بالاستعمار الفرنسي». ولا شك في أن هناك مجموعة من العوامل كانت حاسمة في جعل الفلسطينيين والعرب يصمون آذانهم، في تلك الفترة، عن مثل تلك الكلمات التي أرادها بورقيبة أن تكون «عمادا» لهم «إلى جانب العاطفة والحماس والقصائد الملتهبة»، على حد تعبيره، وحالت دون أن يفكروا فيها ويطرحوا المقترح الذي عرضه عليهم على بساط الدرس.
لقد كان شعار المرحلة هو تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وكانت كل المؤشرات تدل على أن تلك المهمة ستظل ملقاة فقط على عاتق الجيوش العربية الجرارة، التي سيكون بمقدورها وحدها أن تنقض على الكيان الغاصب وتضعه بين فكي كماشة وتدمره في أيام قليلة، إن لم يكن في بضع ساعات. كما كان المشهد متسما بنوع من الانكفاء الفلسطيني والترقب للخطوات التي ستقررها الدول العربية، إذ لم يكد يمضي في تلك الفترة سوى أسابيع قليلة على إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، التي تولت قيادة الكفاح وصارت في ما بعد الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وكل ذلك يطرح في الواقع سؤالا تاريخيا مفصليا وهو هل كان انخراط الأنظمة العربية، وتدخلها بالشكل الذي حصل حينها وسعيها بشكل أو بآخر إلى احتكار القضية الفلسطينية، وربما حتى المتاجرة بها، مقابل الحرص على إبعاد أصحابها الشرعيين، أي أهل فلسطين وإقصائهم عن دائرة التفكير في الخطط المناسبة للتعاطي معها، كان واحدا من بين العوامل الكبرى التي أدت إلى الحاق أفدح الخسائر والأضرار بها؟
إن ما قد ينساه البعض هنا، وفي خضم ذلك، هو أن هناك رئيسا عربيا خرج قليلا عن السرب، ونبّه في وقت باكر نسبيا، أي شهور قبل هزيمة 1967 إلى مخاطر مثل تلك التصرفات. لقد قال بورقيبة وفي أول كلمة له في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في القاهرة في يناير 1964: «لقد انعقدت في الماضي اجتماعات عديدة ضمت ملوكا ورؤساء، ولم تسفر تلك الندوات عن نتيجة. وفي كل مرة كان الفشل يعزى إلى سبب من الأسباب، سواء في الداخل أو في الخارج. والحقيقة أن العلة الأصلية واحدة وهي، أن العزائم كان ينقصها الصدق والإخلاص والقوة على مجابهة الواقع، وتغليب العقل على العواطف المشبوبة والمشاعر الجامحة. فكانت الخطب واللوائح والمواقف المتطرفة، التي لا تتناسب مع الإمكانيات والوسائل التي بأيدي العرب». ثم مضى ليحاجج بأنه «إذا سلمنا بهذه الحقيقة المبدئية وهي أن القضية الفلسطينية قضية استعمار، فإن علاجها يجب أن يكون أيضا بطرق شبيهة بالتي اتبعتها الشعوب المولّى عليها لنيل استقلالها. وإذا حللنا هذه الطرائق الكفاحية، سواء في افريقيا أو في آسيا، وسواء في مصر أو في تونس، وسواء في فيتنام أو في الجزائر، وجدنا أن النصر لم يكن في يوم من الأيام نتيجة حرب بين جيشين تفوق فيها الشعب المستعمَر على الدولة المستعمِرة له، بل هو دائما وأبدا نتيجة صراع طويل يعبر فيه الشعب عن عزمه على مواصلة الكفاح والتضحية المتناهية والاستماتة، بحيث يجعل الغاصب بين أمرين، إما أن يقبل الصراع الطويل المنهك إلى ما لا نهاية له، وهذا ما لا يرتضيه المستعمِر إذ أن هدفه الذي من أجله فرض سيطرته هو إنماء ثرواته وتوسيع الرفاهية لأبنائه، وإما أن يتخلى عن الميدان ارتكابا لأخف الضررين، بعد أن ييأس من الغلبة، أي من استتباب الأمن لفائدته».
النقطة المحورية التي دار حولها ذلك الخطاب الطويل كانت ضرورة اضطلاع الفلسطينيين بالدور الأول والأساسي في تحرير أرضهم، وأن لا يبقوا في موقع المتفرج أو المنتظر للإجراءات والقرارات والتحركات العربية. لقد قالها بورقيبة للعرب بوضوح تام أنتم لن تفلحوا في تحرير فلسطين، إذا تمسكتم بانتهاج سبيل الحرب الكلاسيكية معها لأن «إسرائيل أقوى منا جميعا، بما لديها من إمكانيات داخلية وخارجية»، على حد تعبيره. ومن هنا فإنه ينبغي وضع المشكل في إطاره الحقيقي وهو فلسطين، ثم العمل على أن يصبح ذلك المشكل شغل العالم بأسره و»لن يتأتى ذلك إلا إذا قام أبناء فلسطين برد الفعل المباشر المستمر المتواصل، مهما كانت التكاليف، مع قيادة رشيدة ووعي كامل وروح جامحة»، مطالبا وبشكل صريح ومباشر بإطلاق المقاومة ضد المحتل، وأن يكون محورها فلسطين. «وفي قلب المدن وعبر الصحراء وفي قمم الجبال»، ومؤكدا للفلسطينيين في هذا الصدد أن الأمر ليس فوق طاقتهم وأن العبرة ليست بكثرة العدد ولا بضخامة العدة التي بأيديهم. فالعبرة أولا وقبل كل شيء بروح المقاومة وبدوام المضايقة والعبرة أيضا بتدبير الأمور وتصريف الحوادث». وسواء تنبأ بها أم لا، فإن كل تلك المعاني قد تجسمت اليوم بالفعل وبعد ستين عاما في عملية طوفان الأقصى.
نزار بولحية كاتب وصحافي من تونس